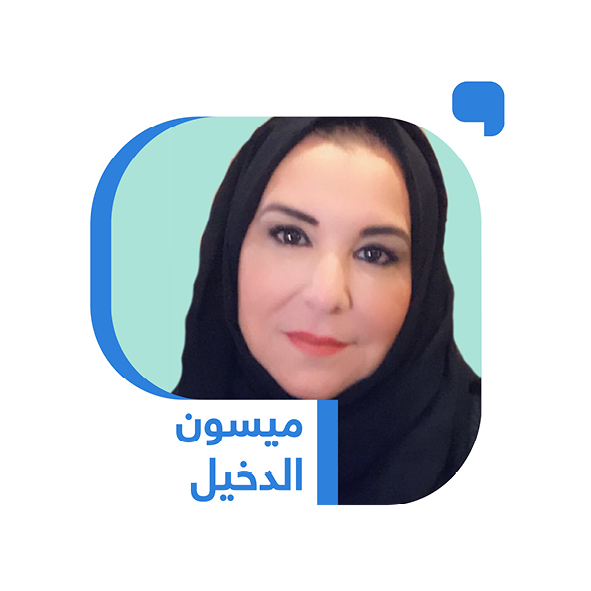يمكن إرجاع أصول تجارة الأسلحة إلى قرون مضت، حيث تطورت شركات تصنيع الأسلحة من منتجين صغار إلى شركات متعددة الجنسيات تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي كبير. وغالبًا ما تتشابك الجهات الفاعلة الرئيسية في صناعة الأسلحة - مثل لوكهيد مارتن وبوينغ وبي أيه إي سيستمز - مع الحكومات، مما يعزز العلاقات التي يمكن أن تؤدي إلى سياسات تفضل العسكرة على الدبلوماسية، ولا نحتاج إلى أكثر من دراسة التأييد الذي يحظى به الكيان المحتل من خلال تزويده بالسلاح والعتاد غير المحدود وغير المشروط كمثال لنفوذهم!
وفي النزاعات الحديثة كالتي نعيشها اليوم، تزدهر تجارة الأسلحة، وغالباً ما تؤدي إلى تفاقم العنف وإطالة أمد الحروب، وتتلقى البلدان المتورطة في النزاعات شحنات أسلحة تشجع طرفًا على حساب طرف آخر، بالنسبة لهم البشر أو الضحايا مجرد أرقام، بل فئران دراسة لأسلحتهم على أرض الواقع، المهم ألّا يتم توثيق تلك الخروقات ونشرها!
وعلاوة على ذلك تتشابك اقتصادات العديد من البلدان مع مجمعاتها الصناعية العسكرية، مما يخلق دورة يمكن أن تطغى فيها المصالح الاقتصادية على الاعتبارات الإنسانية كما ذكرت سابقًا. كما أنه غالبًا ما ترتبط الوظائف والاستثمارات والنمو الاقتصادي بإنتاج الأسلحة، مما يؤدي إلى مقاومة السياسات التي من شأنها خفض الإنفاق العسكري أو تعزيز نزع السلاح.
يلعب تجار الأسلحة، الذين غالباً ما يعملون في الخفاء، دوراً محورياً في تأجيج الصراع، لذا لا تجد سلاماً على وجه الأرض، يجب أن يستمر إشعال الحروب وإلا كانت خسارة كبيرة لهم! إنهم يستغلون حالة عدم الاستقرار، ويزودون مختلف الفصائل بالأسلحة - وأحياناً دون اعتبار للعواقب. وبهذا تؤدي أنشطتهم إلى تقويض عمليات السلام وإطالة أمد المعاناة.
ويضيف المتعاقدون العسكريون غير الرسميين أو المرتزقة طبقة أخرى إلى هذه الديناميكية المعقدة، فغالباً ما يعملون في مناطق النزاع دون مساءلة، ويمكنهم تصعيد العنف وتعقيد مفاوضات السلام! ويمكن لوجودهم أن يجعل من الصعب على الحكومات الشرعية استعادة السيطرة، مما يؤدي إلى وضع لا يصعب فيه تحقيق السلام فحسب، بل قد يكون من الخطورة بمكان السعي لتحقيقه.
عندما يعطي صانعو القرار الأولوية للحلول العسكرية، فإن ذلك لا يشجع على المشاركة الدبلوماسية والتفاوض، كما أنه في العديد من الحالات، قد تشعر الأطراف المتورطة في النزاع بالتمكين لمواصلة القتال، معتقدين أن بإمكانهم كسب اليد العليا من خلال الوسائل العسكرية بدلاً من السعي إلى التسوية، كما يحدث بالنسبة للكيان الصهيوني المحتل علاوة على أنه أصلا لا يبحث عن تسوية! بالنسبة له خريطة «إسرائيل الكبرى» لم تتحقق بعد، ولكن قد يضعه في «خانة اليك» مما يجبره على التحرك في مسار إعطاء الشعب الفلسطيني حقه بإقامة دولة.
ليت الأمر ينتهي عند ذلك، بل إن مناطق الصراعات تستخدم لتجربة الأسلحة، وهذا بحد ذاته أمر يثير مخاوف أخلاقية وإنسانية بسبب الطبيعة العشوائية للحرب الحديثة، والتي غالبًا ما تنطوي على تحمل المدنيين وطأة التقنيات العسكرية الجديدة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الممارسة إلى عواقب كارثية على السكان المدنيين، هل نحتاج إلى أمثلة؟ ما علينا إلا الرجوع إلى الوثائق التاريخية عن ضحايا الحروب ليس فقط من المدنيين بل أيضًا من الجنود على الأرض كما حدث في فيتنام.
تفاقم النزاعات القائمة يخلق حلقة خطيرة من ردود الفعل، حيث يتم إعطاء الأولوية للأرباح على حساب الأرواح! وغالباً ما يؤدي غياب الرقابة في اختبار الأسلحة ونشرها إلى تداعيات غير موثقة بشكل جيد، مما يعيق المساءلة عن جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي، رغم أن مقاطع الإبادة التي يرتكبها الكيان قد وصلت إلى جميع أصقاع الكرة الأرضية، نجد أن الحكومات المناصرة للكيان لا تعترف بها، لا بل تنكرها وتعتبرها نتيجة مؤسفة لكن ضرورية لــ «الدفاع عن النفس»، وهذا بالضبط ما يوضح تشابك الأهداف العسكرية مع مصالح الشركات التي لديها مجالس ضغط عند كل واحدة منهم!
إن إعطاء الأولوية للأرباح على حساب الأرواح يعيق مفاوضات السلام ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية. هم يدركون ذلك تمامًا، ويدركون أيضًا أن المال والسلطة فوق حياة المدنيين، هم بلا دين بلا أخلاق بلا قيم يعبدون أنفسهم معتبرين أنهم فوق كل قانون!
واليوم، يزدهر تجار الموت خلف ستار من الازدواجية والحملات الإعلامية الخبيثة والماكرة، لقد جندوا واستحلوا وسائل الإعلام الرئيسة والأوساط السياسية والأكاديمية في تكتلهم، لكن جرائمهم باتت واضحة، والأدلة الدامغة تتواتر، فأينما ذهبوا تتبعهم المعاناة والموت، وجرائم الحرب والفظائع، والأرباح، وعمليات إعادة شراء الأسهم!
يجب أن يحاسب تجار الموت على مساعدة وتحريض حكومات العالم الغربي؛ التي نصبت نفسها شرطة على باقي الدول، على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. يجب أن تؤسس محكمة لجرائم الحرب، غير تابعة للأمم المتحدة، تُعطى النفوذ والسلطة اللازمة كي تسلط الضوء على أولئك الذين يستفيدون من الحرب، كما يجب أن تسعى إلى إنهاء امتيازهم الدموي. فلتكن هذه المرة هي المرة الأخيرة التي يتحرك فيها المجتمع الدولي. فقد لا تتاح لنا فرصة أخرى!