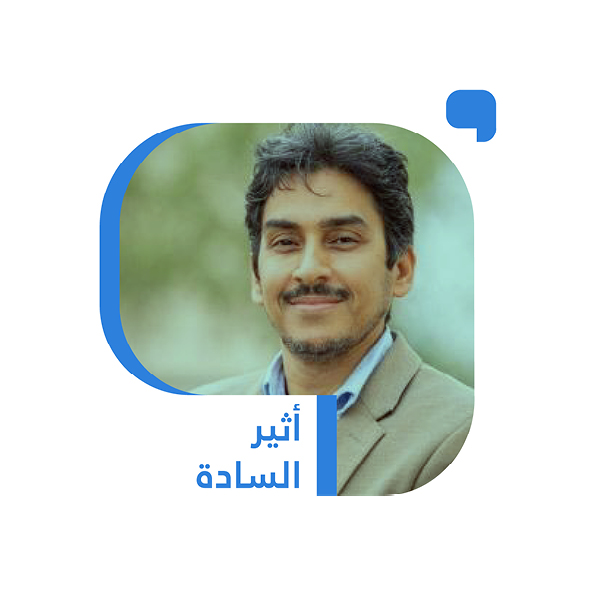للمهرجان ذاكرة عميقة، وحظوة كبيرة لدى المنشغلين بتطوير الممارسة المسرحية خليجياً وعربياً، لذلك كانت الدورات السابقة تمثل مساحة للتفكير في المسرح مثلما كانت تمثل مساحة لعرض التجارب الإقليمية ومراجعتها ورفع التوصيات لتطويرها... كذلك مساحة للحوار والتواصل بين المسرحيين الخليجيين، وبينهم وبين الفنانين والأكاديميين العرب الذين اعتادوا المشاركة في الحلقات والحوارات الفكرية فيها.. أسماء مهمة كانت شاهدة على ولادة هذا الحدث الثقافي غيبها الموت، كانت بالأمس بمثابة الرافعة الثقافية له، يتقدمهم البحريني الراحل الدكتور إبراهيم غلوم الذي يمكن للمتابع أن يرصد بصماته في صمود المهرجان واستمراره، وفي طبيعة برامجه وندواته، كذلك فؤاد الشطي الذي كان حاضراً منذ التأسيس حتى اللحظات الأخيرة من حياته، منظراً، ومعقباً، ومشاركاً في إدارة هذا الحدث، وآخرون ممن كانوا يمسكون بشعلة التحديث والتطوير في فضاءات المسرح.
يحسب للمهرجان أنه لا يزال حياً رغم مرضه لسنوات، وهناك كثير من المهرجانات عندنا تموت في منتصف الطريق، وأنه لم يبدل من اسمه، ولدينا في هذا البلد الكريم في كل يوم اسم ورسم لمهرجان جديد، وأنه اختط لنفسه هوية ورؤية، وسقف طموحات عالية، وإن لم تكن العروض التي تشارك غالباً تسايره وتجاريه في هذه الطموحات، فكثيراً ما كان التذبذب حاضراً في الدورات السابقة، والتباين في جودة الأعمال سواء على مستوى الطرح أو على مستوى الإخراج.
كما أن المهرجان الذي ينعقد كل عامين لم يسبق له أن زار البلاد، فإن الجوائز التي توزعها لجان التحكيم فيه لم تعرف خزائن العروض السعودية يوماً، كلما انطفأت الأنوار في خاتمة المهرجانات خرجت عروضنا المحلية بخفي حنين أو ما يزيد على ذلك قليلاً. أكاد أسمع صدى الهمهمات التي تطوف في أركان المهرجانات السابقة، للمشاركين السعوديين وهم يشعرون بأن هنالك خصوصية في التعامل مع عروضهم، ثمة تركيز دائم على طبيعة ظروفهم حين التقييم والمراجعة، تلك الظروف التي من المفترض أنها تغيرت، وتبدلت، حين أصبح للمسرحيين مواعيدهم ومناسباتهم التي من خلالها ينثرون البهجة، كما ينثرون بذور الأمل لمسرح جديد.
أغبط العابرين من هذا المهرجان في الرياض، وأتمنى لو كان مكانه هنا على الساحل الشرقي، قريباً من شرفات المسرح الكثيرة التي عرفت الضوء منذ البدايات، وقريباً من المجموعات المسرحية التي أذنت مراراً في ليالي هذا المهرجان تحديداً، حيث النصيب الأوفر في المشاركة لفرق جمعية الثقافة والفنون بفرعي الدمام والأحساء، وهذه الأخيرة- أي فرقة الأحساء- هي من سيقدم العرض السعودي في المهرجان القادم.. هنا كثير من الفرق المسرحية التي نشطت داخل جمعيات الثقافة والفنون وخارجها، قبل أن تفتح الأبواب باتساعها للتنشيط السياحي، والمسرح التجاري. فرق نراها تزدحم على أبواب المهرجانات التي كانت تقام بميزانيات محدودة طيلة أكثر من عقدين في طرف الساحل، قبل أن تحط برحالها عند مركز «إثراء» ومهرجانه المنسوخ من مهرجان جمعية الثقافة والفنون بالدمام للعروض القصيرة.
بالطبع هنالك مدن كثيرة بطول الوطن تتشارك في هذا الهم المسرحي، ومنها الطائف وجدة والمدينة وجازان، بجامعاتها وجمعياتها، ومعها الرياض التي كلما تذكرناها مسرحياً حملتنا الذاكرة إلى نضالات المسرحيين فيها، وفي مقدمتهم الراحل محمد العثيم الذي كان يجاهد في فتح شبابيك الوطن على المسرح، يكتب النصوص، ويقيم الدورات، ويقدم الدروس عبر الجامعة، وكلما حاصروا له حلماً، احتال عليه بأمل جديد... كل هذه المدن تستحق أن تكون محطة لمهرجانات المسرح، المحلية والخليجية وحتى العربية.