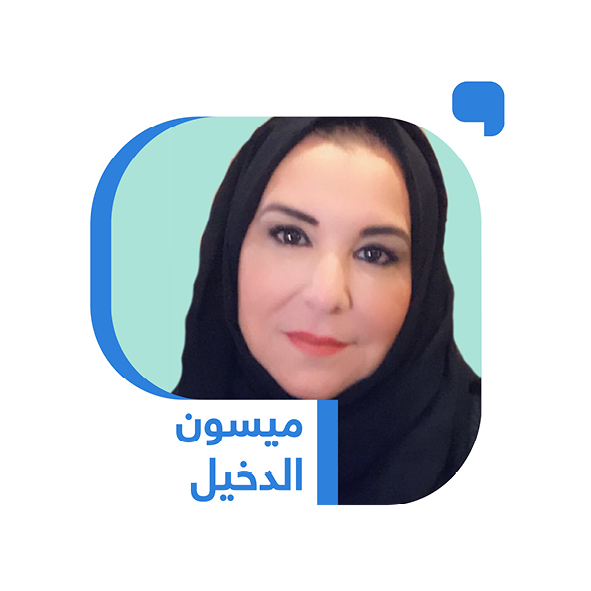تقول القصة الأولى بأنه في قديم الزمان أختار رجلا من قرية تيسًا ليمثل كل أهالي القرية، وألقى عليه خطايا الجميع، ثم أطلقه في البرية؛ كان حلًا جعل جميع أهالي القرية يشعرون بارتياح كبير لتحررهم من خطاياهم - بغض النظر عن نوعية تلك الخطايا.
شعر الجميع بالتحسن، وعلى الرغم من أنهم لم يحددوا خطاياهم أو حتى يكفروا عنها، وافقوا بكل بساطة على تعليقها على التيس، وإن كانت العملية برمتها تمثل منطقًا زائفًا وواضحا لأي أحد منهم، لم تتم مناقشته؛ كان منطقهم «لماذا التشكيك في وسيلة تمت الموافقة الجمعية عليها لجعل الجميع يشعرون بالتحسن»؟!
الآن ماذا عن التيس؟ فلقد تم اختياره من ضمن القطيع وإرساله إلى البرية لأسباب تتعلق بخطايا الآخرين، وهو لم يفعل شيئًا يستحق عليه النفي! وجد التيس نفسه وحيدًا في برية، معزولًا عن بقية القطيع، في منطقة مجهولة، مجبر فجأة على الاعتماد على نفسه في مواجهة مخاطر الحيوانات المفترسة، وصعوبة العثور على الطعام والقوت والمأوى؛ وعاش حالة عدم الأمان الذي يعيشها أي حيوان داجن دون حماية قطيع! الشاهد هنا: ماذا يفعل الإنسان حينما يريد أن يتخلص من ذنب أو يشعر بالدونية؟ يختار ضحية لكي يرمي عليها كل أخطائه، مجرد أن يتم الإشارة إلى الضحية والتحريض، يتوقف التفكير ويبدأ الهجوم، كلِ يعتبر نفسه الأفضل، وكلٍ سيعتبر نفسه ملاكًا لو أن هنالك فقط من سيحمل الذنوب عنه، عندها سوف يشعرون بالارتياح!
أما القصة الثانية فلقد نشرها بنجامين فرانكلين في صحيفة مشهورة في ذلك الوقت، وتدور حسبما ذكره حول محاكمة سحرة في «ماونت هولي» في 12 أكتوبر 1730، حيث تم سحب شخصان متهمان بالسحر: رجل وامرأة لم يتم ذكر اسميهما، إلى حبل المشنقة بالمدينة أمام جمهور تكون من ثلاثة مائة ليتم عرضهما للمحاكمة التي كانت عبارة عن اختباران يحددان ذنبهما، في البداية تم وضع كتاب مقدس كبير على جانب واحد من الميزان. ليجلس كل منهما بدوره على الجانب الآخر من الميزان، ولو رجحت كفة الكتاب على المتهم، لاعتبر ذلك إدانة بالسحر ويتم الشنق، وإذا كان رجحت كفة المتهم على الكتاب المقدس، يعتبر حينها أنه غير مذنب، وعندما رجحت كفة المتهمان تم إجراء الاختبار الثاني حيث يتم ربط يدا المتهم بالحبل ويرمى في النهر، فإن غرق فهو بريء وإن طاف فهو مذنب! عدالة فجة، لكن الاتهامات خطيرة فلقد ذكرت صحيفة بنسلفانيا أن «المتهمين اتُهموا بجعل خراف جيرانهم ترقص بطريقة غير عادية، وبجعل الخنازير تتحدث وتغني المزامير، مما أثار الرعب والدهشة للرعايا الطيبين والمسالمين في هذه المقاطعة»! حادثة وهمية نشرها فرانكلين، بالطبع بتفاصيل همجية صادمة، على أنها هجاء، مستخدمًا الأسلوب الساخر اللاذع ليبين ما يفعله الخوف والعاطفة عندما يُضرب بعرض الحائط كل تعاليم الدين من الرحمة والإنسانية وإغلاق العقل عند التعامل مع الحقيقة بدلاً من استخدام العقل مع الإنسانية والقيم، والناتج هو التوحش في المعاملة عدى عن تضليل للعدالة! غالبًا ما يستخدم أسلوب السخرية الصادمة كتصحيح للسلوك البشري، يشير المستخدم بهذه الطريقة ضمنًا إلى مسار للعمل عليه لتحسين أو إصلاح أو تغيير هدف السخرية، وعادة ما يترك الأمر للمستهدف كي يستنتج ذلك بذكائه.
في أواخر عام 2016، اختارت مؤسسة قواميس أكسفورد كلمة «ما بعد الحقيقة» ككلمة العام، وعرفتها بأنها «تتعلق أو تشير إلى الظروف التي تكون فيها الحقائق الموضوعية أقل تأثيرًا في تشكيل الرأي العام من مناشدات المشاعر والمعتقدات الشخصية»، باختصار، يعتقد الناس ما يريدون تصديقه طالما أنهم يشعرون أنه صحيح أو يعطيهم الشعور بالارتياح عن أنفسهم!
هل ينبغي لنا أن نشعر بالقلق الشديد إزاء الأخبار المزيفة التي غزت الإنترنت مؤخرًا، علمًا بأن قصص الخدع قديمة قدم التاريخ؟! نعم، فاليوم ساد الكاذبون ومفبركين الحقائق بشكل مخيف! يعملون على تقديم المعلومات المزخرفة على أنها حقيقية في الروح، بل ويظهرونها على أنها أكثر صدقًا من الحقيقة نفسها!
نحن نعيش في عصر «ما بعد الحقيقة»؛ أي انتشار الأخبار المزيفة على الإنترنت، مثل التعليقات المهينة التي تكاد تكون تشهيرية يتم تحميلها كل يوم على جميع منصات الإنترنت، تقوم على تشويه سمعة المؤسسات أو الأفراد من خلال التعليقات، التي قد تكون معروفة المصدر أحيانًا وأحيانًا كثيرة ما تكون مجهولة!
عادة ما تجذب الأكاذيب انتباهنا وهذا أمر مفهوم للطرق الإبداعية في العرض، رغم أن فعل الكذب بحد ذاته يظل ينطوي على خبث منفر لنا، المهم لكي يكذب المرء، عادة ما تكون النية لفعل ذلك مسبقة؛ إنها ليست زلة بسيطة، بل أمر بذل عليه جهد وتعب! بالنسبة لمن يكذب، الحقيقة لها قيمة وفقًا لأغراضه الخاصة، ومن هنا ينبع اهتمامه بالتلاعب بها، ليصل إلى مبتغاه؛ المنفعة بأي طريقة، الشهرة أو المال أو الاثنان معًا!
عندما لا ننتبه للأخبار التي ننشرها على شبكات التواصل الاجتماعي. نحن لا نُعفى من المسؤولية، لأنه من خلال المشاركة بطريقة ما في أعمال تشهيرية؛ أي عندما يبدو أن ما نقوم به ليس مهمًا، أو نعتقد أن ما نقلناه صحيحًا، لأنه عندما يحدث فذلك لأننا توقفنا عن التفكير في حقيقة أن اللغة ليست مجرد وسيلة لنقل الحقائق والأرقام والاستراتيجيات والبراهين والتفنيد، ولكنها أيضًا حاملة للقيم! من المهم أيضًا أن نأخذ في عين الاعتبار أنه بالرغم من أهمية معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، لا يوضح ذلك بشكل كافٍ ما هو مطلوب لتحقيق العدالة للآخرين، والتصرف انطلاقًا من مشاعر إنسانية حقة، فإن المستخدم أو المستهلك للمعرفة لديه الكلمة الأخيرة، ولديه حرية تمكنه من أن يقرر إعادة ترسيخ قيمة الحقيقة؛ أي تجنب الأكاذيب سواء الشخصية أو عن الآخرين، وتجنب الاعتياد على العيش في ظروف يكون فيها الكذب أمرًا معتادًا ورفض أي نقص في الحقيقة بأي طريقة ممكنة، مهما كانت غير واضحة أو خفية!
يحرص الكاذبون على التصدر وجذب الانتباه من خلال خلق الأخبار أو ليّها بطريقة تشد بسهولة المستخدمين من رواد المواقع والوسائط الإلكترونية الذين يستهلكونها والذين بدورهم يعيدون توزيعها؛ وبذلك يعتبرون المشاركون سواء عن قصد أو غير قصد في «ما بعد الحقيقة»! إن ذلك يعزز عدم الثقة والتوتر في المجتمع، ولهذا السبب، ومن الأهمية بمكان أن ندرك حقيقة ما تشير إليه المعلومات التي نعيد تدويرها دون مراجعة أو تدقيق، لأنه لا يحق لنا أن نتحدث عن القيم إن كنا نشارك بهدمها!