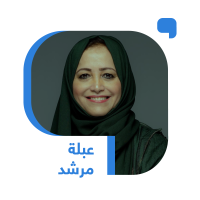كان البحث عن لقمة العيش وموارد المياه المتوفرة في أرض الله الواسعة هو الدافع الرئيس نحو الهجرة من منطقة لأخرى، قريبة كانت أم بعيدة تحقيقاً لغريزة البقاء وسعياً نحو العيش الأفضل، وتلك سنة الحياة التي فطر الإنسان عليها لتستمر الحياة، ويبقى الإنسان خليفة الله في الأرض وليحمل الأمانة على وجه البسيطة، بعد أن تحمل مسؤوليتها التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها مصداقاً لقوله تعالى «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا» (الأحزاب، 72).
تطورت وسائل الهجرة وسبلها واتجاهاتها ومقاصدها مع تطور الإنسان وتراكم المعرفة وزيادة الحاجات الإنسانية للبحث عن حياة أفضل، كما تنوعت أسبابها ما بين هجرة مؤقتة وهجرة دائمة، وما بين هجرة اختيارية وأخرى قسرية بسبب الحروب والاضطهاد وغيره، وكان تطور وسائل النقل والمواصلات من أحد أهم الدوافع والمحفزات نحو زيادة معدلات الهجرة وتيسير الانتقال من منطقة لأخرى بحثاً نحو فرص أفضل، وقد أدى ذلك بدوره إلى مزيد من الانتشار للإنسان في شتى بقاع الأرض واتساع دائرة اختلاطه مع أجناس البشر المختلفة عرقياً وثقافياً ودينياً.
لم تكن الهجرة تخضع لقوانين صارمة أو قيود حضارية أو أنظمة مؤسسية وتشريعات دول، وإنما كانت المسافة والوسيلة والهدف هي المعايير التي توجه المهاجر نحو مقصده، إذ لم تكن هناك حيازات دولية وحدود سياسية فاصلة ما بين الدول إلا مع بدايات القرن العشرين، حيث ظهر مفهوم الدولة بمعناه الحديث الذي نعرفه الآن، وذلك بعد أن كانت سلطات الشعوب وحيازاتها الأرضية تحكمها السيطرة والقوة والنفوذ على مناطق ممتدة تعيش فيها، ويفصلها عن بعضها تخوم انتقالية ومسافات فاصلة شاسعة أحياناً ما بين أقوام وآخرين، بل وحتى تلك التخوم نشأت تدريجياً على مر العصور مع تطور حاجات الإنسان ونمو متطلباته وزيادة السكان، ما أدى إلى تضارب المصالح والنزاع على الموارد المائية والحيازات الأرضية والملكيات وغيرها من الموارد الطبيعية المتوفرة بصورتها الأولية، التي كانت تمثل دعامة الاقتصاد وسند الحياة في تلك المراحل من تطور الحياة البشرية، الذي أدى بدوره لنشأة الدول بمفهومها المعاصر.
من الطبيعي أن يكون لكل جماعة من الناس أو البشر نظام حياة ولغة وعادات وتقاليد وثقافة تمثلهم كبشر وتصبغهم بصبغة معينة تعكس ثقافتهم وهويتهم المحلية التي جمعتهم في أرض واحدة وتلونت بموروثهم عبر أجيال يجملها الآباء عن الأجداد إلى الأبناء، وهكذا ينتقل الموروث ويحفظ التراث عبر العصور في شتى بقاع الأرض، ومن الطبيعي كذلك أن هؤلاء المهاجرين من شتى أنحاء الأرض، أنهم يحملون هويتهم وثقافتهم إلى مناطق المهجر التي اختاروها للعيش لأسباب مختلفة، ولأن الإنسان اجتماعي بطبعه، وبحكم الاختلاط يحصل التزاوج وتختلط الأنساب ما بين سكان الأرض جميعهم، وتلك سنة الحياة وطبيعتها المألوفة في جميع الحضارات الإنسانية، وبذلك تختلط الثقافات وتندمج الهويات وتتداخل الأصول والأعراق، لتكون نسيجاً اجتماعياً مختلفاً يعكس طبيعة الحضارة البشرية ويثريها بمكونه الإنساني، وذلك يفسر مصادر كثير من الموروثات التي نجدها بيننا، ويجيب عن تساؤلات واستفهامات كثير ممن تغيب عنهم تلك الحقائق العلمية وطبيعة التاريخ المتوارث.
لا توجد هناك أصالة ونقاء وصفوة لبعض الأجناس أو الأعراق أو الثقافات، لأن ذلك يخالف حقيقة التطور البشري والهجرة الطبيعية والتزاوج المتوارث، بل ويناقض سمة تداخل الحضارات وإفرازاتها المكتسبة، وإن وجد فلا يكون إلا في الجهات النائية البعيدة أو الأدغال والغابات أو أعالي الجبال المرتفعة المعزولة، من أولئك الذين يعيشون كجماعات وأقوام منعزلين عن البشر، في أعالي جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية وأعالي الهمالايا في آسيا والمناطق التي تنتشر فيها الغابات الكثيفة حول خط الاستواء في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وآسيا، بل وحتى هؤلاء مع تقدم العصر وانتشار وسائل الاتصال وتطور النقل ونشوء الدول بمعناها الحديث، لا نجد منهم إلا النادر الغريب، لأن مفهوم الدولة الحديثة تذوب في داخله وضمن إطاره جميع الجماعات البشرية بثقافاتها المختلفة وأصولها المتباينة وانتماءاتها المتعددة، لتكون هناك هوية وطنية تجمع تلك القوميات والشعوب المختلفة في ظلها، بما حملته من موروث وما اكتسبته من ثقافات لاحقة شكلت هويتها الحضارية المعاصرة.
الموروث التاريخي والتراث الثقافي بجميع مضمونه، هو إرث متراكم ومكتسبات غير قابلة للانتقائية والتفصيل لأنه يظل سمة وهوية تتمايز بها الجماعات البشرية في مفرداتها المكونة لثقافتها المتوارثة محلياً والمكتسبة مع تداخل الحضارات، فكم من المأكولات والمشروبات والعادات التي تمثلنا على الرغم من أنها وافدة إلينا منذ قرون مضت، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الأرز كأكلة شعبية تمثلنا دولياً، على الرغم من أننا لا نزرعه لأن بيئتنا الطبيعية ومواردنا المائية لا تناسب زراعته، وذلك على الرغم من انتشاره كغلة رئيسة شعبية يستند عليها غذاؤنا اليومي مع أنه سلعة وافدة إلينا مع التجار والمهاجرين من جنوب آسيا وشرقها.