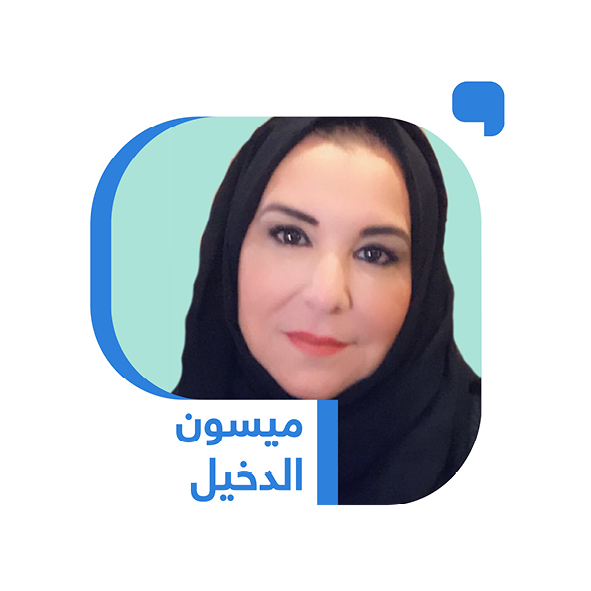عرّف المختصون «العجز المكتسب» على أنه حالة تحدث بعد تعرض الشخص لموقف سلبي بشكل متكرر، وعليه ينمو لديه الاعتقاد بأنه لا يمتلك القدرة على تجنب الأذى أو الفشل، حيث إنه قد درب عقله على الإيمان بأنه ليست لديه السيطرة أو التحكم بالموقف أو تغييره، لذا فهو لا يحاول، حتى عندما تتاح أمامه فرص التغيير، وهذا أمر خطير، لأنه يولد دورة من التفكير الانهزامي الذاتي!.
هل تمر بمثل هذه الخبرات في بيئة العمل؟: تمنعك السياسة المتبعة في المؤسسة التي تنتمي إليها من عمل أنت متحمس له - وجود مشكلات بلا حل، لأنك غير قادر على معالجتها بنفسك، ولا يهتم من حولك بأي مبادرة لتغيير الوضع، لأنه ببساطة لا يوجد أي اهتمام - الحصار من زميل أو رئيس عمل لئيم يداوم على إلقاء اللوم عليك، بل ويحرجك علنا بشكل متكرر - تجد نفسك تحت إمرة مدير يضع مواعيد نهائية غير واقعية تضغط عليك لساعات عمل إضافية، لمحاولة القيام بالمستحيل - مقيد ببيئة سامة ذات ثقافة فاسدة وغير أخلاقية، تعرضك وبشكل متكرر لسلوكيات تتعارض بشكل كبير مع قيمك ومبادئك!. الآن سواء كنت متفائلا أو متشائما يمكن أن يؤثر كل ذلك في مستوى تحملك مثل هذه الأنواع من الضغوط والمشكلات، وبالنهاية سيفقد أي شخص الأمل، ويصبح أمامه خياران: إما أن يصبح بلا اهتمام، ويستمر في تلقي الضربات، وإما أن يترك العمل، لأن الموظف الذي بدأ بكل همة ونشاط، ويسعى للعمل بجد، سيجد صعوبة أكثر فأكثر في أداء عمله، وفي مرحلة ما سوف يستسلم، وهذا ما يجب أن يجعلنا نعيد التفكير بالأسباب التي تقبع وراء تسرب نسب لا يمكن تجاهلها من الشباب من العمل؟.
هل هذه الظاهرة مفيدة في بيئة العمل فقط؟ بالتأكيد كلا!. لننظر إلى بيئة العالم الافتراضي، ولنأخذ كمثال فقط من تتم متابعتهم من مشاهير التواصل الاجتماعي، وهنا نجد أن ما يبث لا يمثل حقيقة الحياة التي يعيشونها، فما نراه ليس سوى مقاطع لأفضل اللحظات وأكثرها متعة بدلا من أن نراهم عالقين بين أكوام من المهام والأعمال المرهقة أو حتى في لحظات يأس أو فشل. وعليه تخلق ذلك لدينا صور خاطئة عن حياة يصعب مواكبتها أو حتى تقليدها، وهذا العجز يؤدي إلى البحث عن المزيد من المشاهد المماثلة كمحاولة للتعويض عن النقص. وبدلا من أن نعيش في عالمنا الحقيقي، ونعمل على تغييره إلى الأحسن، نسجن أنفسنا في عالم افتراضي يعطينا الشعور بالسعادة للحظات، وتمضي ونمضي خلفها، طلبا بالمزيد، إلى أن يتحول الأمر إلى إدمان!.
نظرا لأن «العجز التعلمي» هو سلوك مكتسب، فهناك طرق يمكن من خلالها عدم تعلمه، والعامل الأكثر أهمية هنا هو إدراك الفرد أنه المسيطر، فعندما نركز على الأشياء التي ليست لدينا سيطرة عليها، يقودنا ذلك إلى الشعور باليأس من تغيير الوضع، ولهذا بدلا من القيام بذلك لنركز على الأشياء التي يمكننا التحكم بها، فنحن هنا نضع أنفسنا في وضع يسمح لنا بالعمل على تحسين وضعنا. خطوات صغيرة نتخذها نحو تحقيق النتائج التي نسعى إليها، ربما لن نتمكن من تغيير الموقف بالكامل، ولكن ربما يحدث تحسن في أجزاء صغيرة منه، ولنحاول أن نأخذ الأمور بطريقة أكثر إيجابية، عندها سنرى النكسات والإخفاقات على أنها مؤقتة وفردية، وبهذا سيتولد لدينا الشعور بأن الأمور ستتحسن، لأن أحد الآثار الجانبية للتفاؤل هو تحسين مستويات الطاقة، وإذا كان لدينا المزيد منها، فهذا يعني زيادة في الإنتاجية، وكلما أصبحنا أكثر إنتاجية كنا أكثر نجاحا، فعن طريق تغيير وجهة النظر والتنبه لإمكانية تحسين الوضع الحالي سيتحسن بالفعل، وما كنا نعتقد أنه من المستحيل تغييره، في الواقع يمكن أن يتغير، فقط من خلال تبني نظرة مختلفة للحياة، منطلقة من التفاؤل. ولكي نصبح أكثر تفاؤلا، علينا أن نحصي نِعم الله علينا، فغالبا ما تأخذنا الحياة، وننسى أننا نعيش في ظل كريم وهّاب، ولنرسل لأنفسنا رسائل إيجابية كأن نقول: «هذه حالة واحدة فقط، والحياة ربح وخسارة»، ولنقنع أنفسنا بأننا قادرون على فعل شيء، وبإمكاننا تحريك الوضع حتى ولو كان بمثابة قذف حجر صغير في بحيرة راكدة. لنفعل ذلك، وسوف نرى أن ما يبدأ صغيرا يتمدد ويتسع. نعم، إنه أمر صعب أن نتبنى حالة ذهنية جديدة؛ بأن نركز على النصف المليء من الكوب بدلا من النصف الفارغ، لكن لنكن على ثقة في أن هذه الرؤية موجودة في مكان ما داخل كل واحد منا، وأنا كلي تفاؤل بأننا بقليل من التركيز والإصرار، بإذن الله قادرون على إيجادها وتفعيلها.