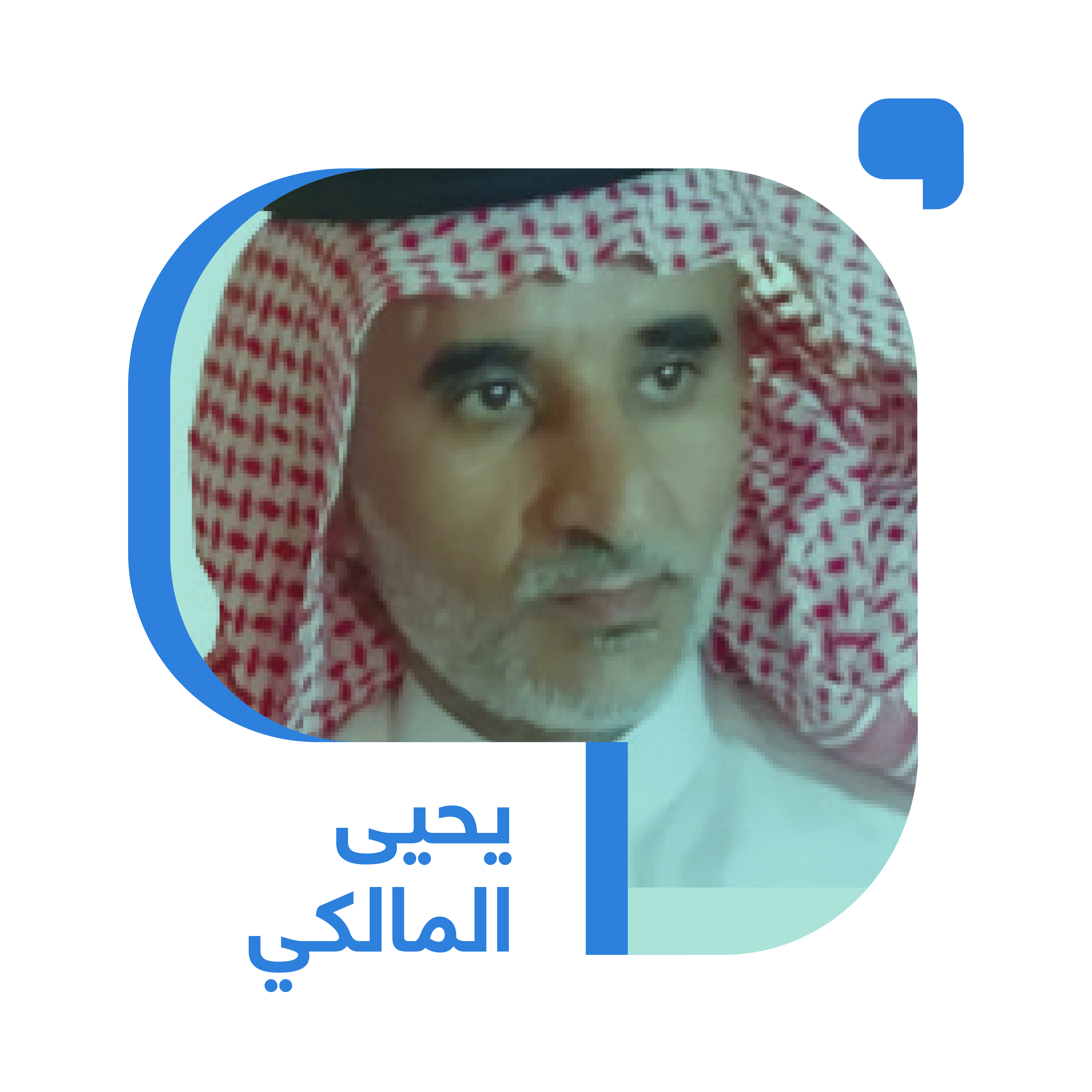فلماذا نشأت هذه الحاجة التي تقضي بفرض الرقابة على الذوق وحمايته؟ ومن أين نبعت مفسدات الذوق التي ولدت من رحمها مفردات مخالفات الذائقة المنتهية بفرض غرامات مالية لحفظ قيمنا الأخلاقية؟ إنها أسئلة تتطلب إجابات مفتوحة النهايات، يحسن الإسهاب فيها لشرح زوايا المشكلة، وتحسس مكامن الخلل الذي أدى بنا إلى إنتاج هذه اللائحة، التي تحكي معاناتنا الأخلاقية، وإفلاسنا التربوي في حماية القيم! ألجأنا إلى الجانب التنظيمي الرقابي العقابي.
ليس حسنا أن ننظر إلى هذه اللائحة بإيجابية تامة، على أنها حرز ذوقنا، وحارس فضيلتنا، فالنظر إليها من هذه الزاوية يعني أننا بعيدون عن فهم المشكلة، كما أنه ليس من الإيجابي ارتفاع معدل تطبيق العقوبات يوما بعد يوم، أو اتساع دائرة المخالفة، فهذا يبعدنا عن دورنا المتمثل في الحيلولة دون الحاجة لإيقاع هذه العقوبات، وواجبنا المحوري في السعي الدائم لإسقاط هذه اللائحة! والوقوف بجدية دون تطويرها، أو استحداث بنود أو مواد إضافية، لنحتفل يوما بإلغاء لائحة الذوق العام! باحترامنا للقيم وتربية أبنائنا وبناتنا على المثل الإسلامية والآداب الإنسانية الرفيعة.
كلنا ندرك أن وجود لائحة عقوبات في أي مجال يعدّ دلالة واضحة على مخالفات صارخة بدرجات متفاوتة، تقتضي إيقاع العقوبات المختلفة بقدر درجة المخالفة ونوعها كما في نظام المرور مثلا، والذي وجد لمنع ممارسات إزهاق الأرواح على الطرقات، الناجم عن ارتكاب مخالفات تؤدي إلى ذلك، مثل السرعة بكل درجاتها وصولا إلى التهور، والتفحيط، والتجاوزات على مسارات الآخرين، وغير ذلك من الوقوف الخاطئ، ونظام الإشارات الضوئية، فلولا انتهاكات بعض السائقين لما كانت هناك حاجة لفرض عقوبات السجن، والغرامة، ومصادرة المركبات، وغيرها، ومع ذلك فلم تتوقف تلك الممارسات بتطبيق نظام اللائحة، ولكنه تحول للردع، والتخفيف من وقع النتائج، وفصل الخصومات، ولا زال نزيف المخالفات المرورية وجعا لم تحل دونه التنظيمات واللوائح.
وهذا ما لا نريده في مجال الذوق العام، بالركون لتطبيق اللائحة دون العناية باجتثاث الأسباب التي أدت إلى وجودها، فلا نريد أن نصل إلى أدق التفاصيل، وتفاوت درجات العقوبة في سلم مخالفة الذوق، لأن الاحتكام إلى التنظيم في حفظ القيم والسلوك يعني ضعفا هائلا في الدور التربوي الذي تمارسه الأسرة بكل مكوناتها، والمدرسة بكل مراحلها التعليمية، والجامعة، والمسجد، والمجتمع بكل وجاهاته وقاماته، وعندما تخفق جهودنا في تربية الأبناء، وغرس القيم في نفوس النشء، وإقناعهم بأنها الفارق الحقيقي للتمييز بين كل متضادين [دين ولا دين، رجولة وأنوثة، إنسان ولا إنسان، وتندرج تحت هذه الثلاث مجموعة قيم الذوق العام التفصيلية]، ولكل قيمة إطار محدد ينتهي بخطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن التعدي عليها بأي حال يعدُّ خرقا لنظام المجتمع، وإسقاطا لمكانة الأسرة، ومثلبة تلحق الضرر بالأفراد والمجتمع على حد سواء، وتؤدي إلى عواقب تحرم فاعلها من ميزات اجتماعية، أو وظيفية، أو غير ذلك، وفي حال فشلنا في صيانة هذه المنظومة فإننا حتما سننتقل باللائحة إلى قوة ردع، ننتقي منها نوع العقوبة بناء على نوع مخالفة الذائقة، ونحتاج إليها بنسب متزايدة كلما زادت حدة انحدار السلوك، وسقوط الممارسات إلى قاع لا ينفع معه غير العقاب، بكل أنواعه: ماديا كان، أو نفسيا، أو جسديا.
إن التغير الاجتماعي الناشئ عن التطور الحضاري المدعوم بالثورة التقنية، وغفلتنا عن الفجوة الناجمة في سلوك الجيل، وانشغالنا بضخ فكري لا يتناسب مع ما ينشغل به الجيل، وتركيز المؤسسات المعنية بالتربية فيما مضى على النمذجة الإفلاطونية الفاضلة، والمثالية المسطّحة، وما صاحبه من وعظ غافل عن الواقع، فضلا عن طلائع المستقبل، وما تخلله من صناعة الرموز التي تولت فرض القيود، ومارست هروبها خارج قيود المجتمع للانعتاق من تلك الأغلال، وكسر وثاقها الهش، كل ذلك سوّغ إسقاط الكثير من المبادئ من باب التأسي والاقتداء. ومع ارتفاع أصوات الشعارات الزاعمة حماية حقوق الانسان، وحرية الرأي، ومفاهيم التربية الحديثة، التي أسيء فهمها، وأخرجت عن إطارها الصحيح، فنتج عن ذلك ضعف في موروثنا القيمي، وصلنا به إلى حد من المهازل السلوكية التي أساءت لأصالة مجتمعنا ومكانته، ومنيت فيها فضائل الأخلاق بهزائم مخزية، أفرزت لنا قائمة من العقوبات، يراد منها إيقاف هذا النزيف، وكبح جماح المجاهرة، والعبث بمشاعر الكثيرين الذين يحتفظون بذوق رفيع، أفسده عليهم لئام من الناس بجهل، أو استهتار، أو دسائس.