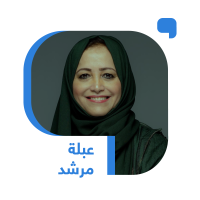يتضمن خلل التركيبة السكانية عددا من المؤشرات أو الخصائص التي تؤكد وجوده، بعضها يتعلق بخصائص التركيب العمري، كأن ترتفع نسبة السكان في عمر الشباب على سبيل المثال، وبعضها يتصل بنسبة النوع، والمرتبط باختلال نسبة الذكور للإناث أو العكس، وبعضها من حيث نسبة المواطنة، بأن ترتفع نسبة المهاجرين (جميع من هم غير مواطنين) لمستوى قد يفقد الدولة هويتها، ويؤثر في درجة التوازن السكاني المعتدل. تتضاعف أهمية الخلل ويتفاقم تأثيره، عند المقارنة «النسبية» لتلك الخصائص مع المواطنين، وليس بعددهم المجرد، بمعنى أنه قد يكون في دولة ما، مثل الولايات المتحدة 51 مليون مهاجر، ولكن لا يعتبر أن لديها خللا كبيرا في التركيبة السكانية، لأن عدد سكانها يربو على 330 مليون نسمة، وهؤلاء المهاجرون لا يكادون يتعدون نسبة 15 % من جملة سكانها، ومثلها في ذلك كل من بريطانيا وفرنسا اللتين لا تتعدى نسبة المهاجرين فيهما 13 %، و12 %، على التوالي بعدد سكان 67 مليونا و65 مليون نسمة (2018).
على المستوى الوطني تشير تقديرات السكان لعام 2018 إلى أن نسبة السكان من المهاجرين (غير المواطنين) والبالغ عددهم 12.645 مليون نسمة في عام 2018، قد قاربت 38 % من جملة سكان المملكة والبالغ عددهم 33.413 مليون نسمة، وقد تضاعفت تلك النسبة على مدى سنوات مضت، فبعد أن كانت نحو 23 % في 2005، ارتفعت إلى نحو 33 % في 2013، لتصل إلى 38 % في 2018!!. وذلك بالطبع لا يتضمن المقيمين غير النظاميين باختلاف أسباب وجودهم! لا يمكننا أن نتجاهل التحديات التي تواجهنا، نتيجة لهذا الخلل في التركيبة السكانية، والذي يلاحظ على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والأمنية والصحية بل والسياسية، لأن ارتفاع نسبة غير المواطنين في أي دولة يضعف النسيج الوطني، ويُسهم في اختراق اللحمة الوطنية والانسجام الاجتماعي، بما يؤثر في الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي الصحيح، ناهيك عن الوضع الصحي الذي تجلى بقوة هذه الأيام والذي دق ناقوس الخطر، مما يدعو إلى الوقوف الحازم نحو الحد من ارتفاع نسبة المهاجرين في الوطن، وذلك يشمل جميع المقيمين، سواء الموجودين منهم بصفة نظامية، وهم المشمولون في تلك النسب أعلاه، أو المقيمين بصفة غير نظامية والذين ترتفع نسبتهم حتى لا يمكن حصرهم.
أظهرت المحنة الصحية التي نعيشها هذه الأيام حجم المخاطر الصحية التي تولدت من ارتفاع نسبة العمالة الوافدة، والتي تتضاءل أمامها جميع ما يبذل نحوها من جهود ونفقات سخية، هناك عمالة تعبث بأمننا الوطني الصحي والاجتماعي والاقتصادي، في مختلف الممارسات اللاأخلاقية التي تنتهك حرمة الوطن ومقدراته، والتي يتحمل مسؤوليتها المواطن قبل غيره، سواء في مسؤوليته الوطنية في أداء ما عليه من التزامات نحوهم، أو في ظل تستره على كثير من العمالة، أو في تجاهله لوجودهم وعدم التبليغ عنهم، أو بالتعاون معهم لمصالح مختلفة.
تشير إحصاءات مسح القوى العاملة وتوزيعها بين مناطق المملكة إلى أن منطقة الرياض تستأثر وحدها بنحو 30 % من جملة العمالة الوافدة، بمن فيهم العمالة المنزلية، وأن نسبة القوى العاملة الوافدة في الرياض تشكل نحو 68 % من جملة القوى العاملة، في حين يمثل المواطنون نسبة 32 % فقط. أما منطقة مكة التي يتقارب حجم سكانها مع منطقة الرياض، فإن القوى العاملة الوافدة تشكل 71 % من جملة العاملين فيها، بينما تنخفض النسبة للمواطن إلى 29 %، وتتقارب المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم مع منطقة مكة بنسبة 70 % للوافدة و30 % للمواطنين. أما منطقة المدينة المنورة فتصل فيها نسبة القوى العاملة الوافدة إلى نسبة 64 %، بينما المواطنون 36 %، وتنخفض نسبة العمالة الوافدة في منطقة عسير إلى 60 % ونحو 40 % للمواطنين. بمتابعة الإحصاءات المنشورة يوميا حول الحالات المستجدة لكورونا في مناطق المملكة، يتضح أن هناك ارتباطا بين ارتفاع نسبة العمالة الوافدة في المنطقة، وبين زيادة عدد الحالات فيها، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بظروف السكن والاختلاط وانخفاض الوعي الصحي، وبمخالفتهم كثيرا من التعليمات لأسباب يتعلق بعضها بمخالفتهم أنظمة الإقامة وغيرها.
لا ننكر أن هناك فئة كبيرة من المقيمين الذين يسهمون في تنمية الوطن، وأننا ما زلنا نحتاج للنخبة منهم، التي تضيف إلى مواردنا البشرية ما تحتاجه من خبرة أو تميز علمي، وذلك شأن جميع دول العالم المتقدم، ولكن المفارقة التي لا بد أن تؤخذ في الاعتبار هي في نوعية ومستوى هذه العمالة الوافد ومهاراتها ومدى الحاجة إليها. نحتاج وبقوة لضبط سياسات الاستقدام بمجالاته كافة، والتي يرتبط بها كثير من التحديات الاجتماعية والأمنية التي نواجهها، كالبطالة والضغط على الخدمات والجرائم بأنواعها، كما نحتاج إلى مراجعة وتحديث السياسات الخاصة بالعمرة والحج والزيارة والسياحة، بما يُسهم في إمكانية ضبط أعداد القادمين والمغادرين والمتخلفين منهم، ويكفل توثيق وجودهم إلكترونيا، سواء بمغادرتهم أو بتتبع وجودهم محليا.
تؤكد الدلائل العلمية وتجارب الدول أن التحديات التنموية لا تظهر فجأة، وأنها ليست وليدة فترة زمنية بسيطة، وليست نتيجة تقاعس جهة رسمية واحدة، وإنما تكون بسبب تراكمات لإخفاقات مؤسسية اشتركت عدة قطاعات في وجودها، نتيجة لمنظومة مختلة من السياسات التنموية غير المتوازنة، والتي تفتقد إلى التنسيق فيما بينها، سواء في وضع السياسات وإجراءاتها أو في تنفيذها، لتكون منجزات لبرامج حقيقية تعكس رؤية إستراتيجية شاملة تحقق أهدافنا الوطنية.